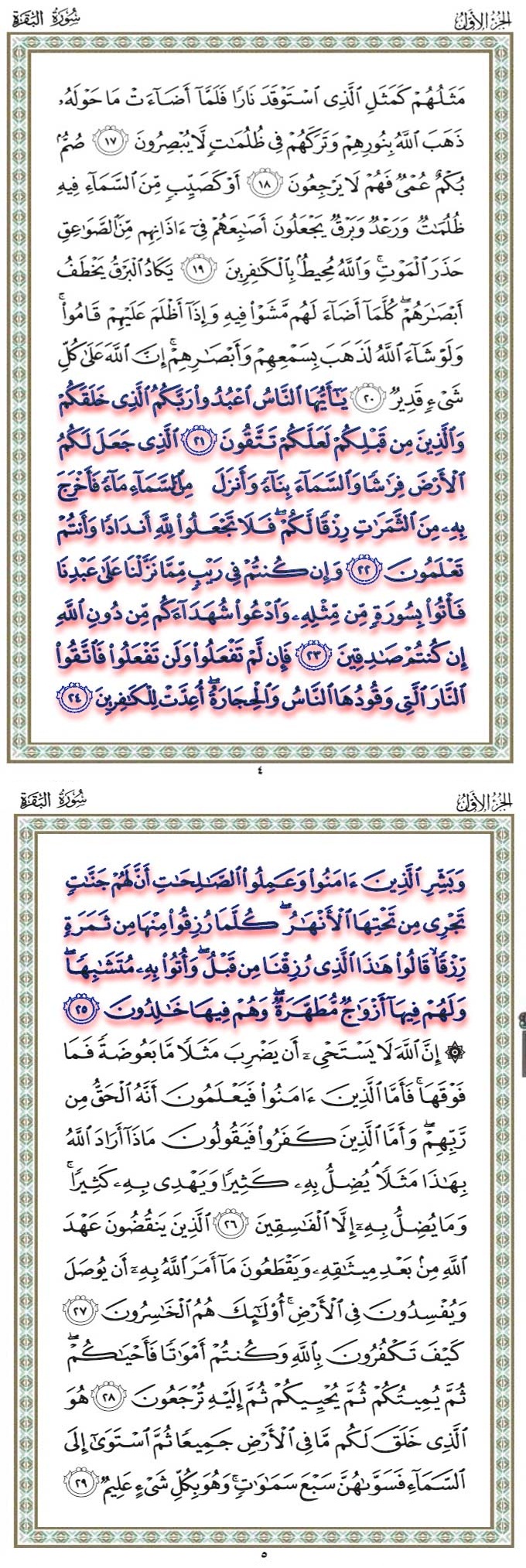بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب
العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
الميزان في تفسير
القرآن
للعلامة السيد محمد
حسين الطباطبائي
تفسير سورة البقرة
إعداد للتفسير الموضوعي
|
{ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)
الم (1) |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
تفسير سورة البقرة (2)
و هي : (286) مائتان و ست و
ثمانون آية .
الآيات 21 إلى 25 .
( تفسير )
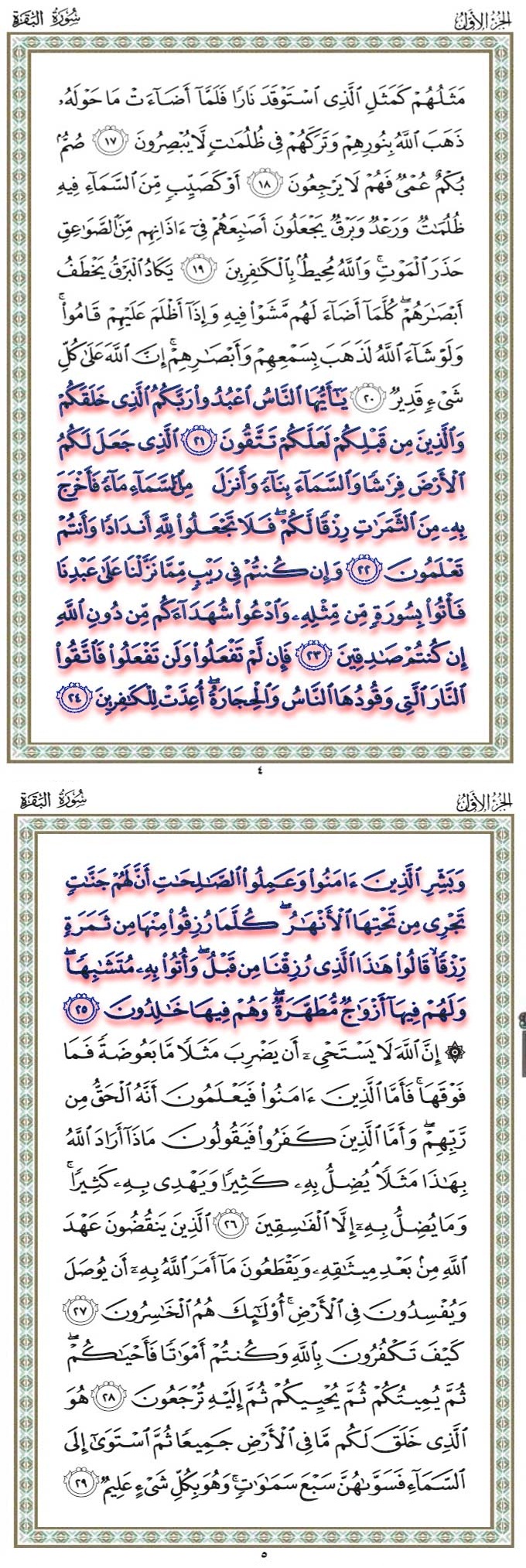
{ يا أَيُّهَا النَّاسُ
اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (21)
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ
مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ
فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22)
وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى
عَبْدِنا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ
وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (23)
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (24)
وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ
أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها
مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ
مُتَشابِهاً
وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فِيها خالِدُونَ (25) } البقرة
.
[سورة البقرة (2): الآيات 21 الى 25]
الميزان في تفسير القرآن ج1ص57.
بيان :
قوله تعالى : { يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا
.....} .
لما بين سبحانه حال الفرق الثلاث :
المتقين ، و الكافرين ،
و المنافقين .
و أن المتقين : على هدى من ربهم ، و القرآن هدى لهم .
و أن الكافرين : مختوم على قلوبهم و على سمعهم ، و
على أبصارهم غشاوة .
و أن المنافقين : مرضى ، و زادهم الله مرضا ، و هم صم
بكم عمي .
و ذلك : في تمام تسع عشرة آية .
فرع تعالى : على ذلك ، أن دعا الناس إلى عبادته ،
و أن يلتحقوا بالمتقين ، دون الكافرين و المنافقين .
بهذه : الآيات الخمس ، إلى قوله : { خالِدُونَ
} .
و هذا السياق يعطي كون قوله : { لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ } ، متعلقا بقوله : { اعْبُدُوا } ، دون قوله : { خَلَقَكُمْ } .
و إن كان : المعنى صحيحا ، على كلا التقديرين.
و قوله تعالى : { فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } .
الأنداد : جمع ند، كمثل ، وزنا و
معنى .
و عدم تقييد قوله تعالى : { وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
} ، بقيد خاص .
و جعله : حالا ، من قوله تعالى { فَلا تَجْعَلُوا } ،
يفيد التأكيد البالغ في النهي .
بأن الإنسان : و له علم ما ، كيفما كان .
لا يجوز له : أن يتخذ لله سبحانه أندادا .
و الحال : أنه سبحانه هو الذي خلقهم ، و الذين من
قبلهم ، ثم نظم النظام الكوني لرزقهم و بقائهم.
الميزان في تفسير القرآن ج1ص58 .
و قوله تعالى : { فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ
مِثْلِهِ } .
أمر تعجيزي : لإبانة إعجاز القرآن ، و أنه
كتاب منزل من عند الله لا ريب فيه .
إعجازا : باقيا بمر الدهور و توالي القرون .
و قد تكرر : في كلامه تعالى هذا التعجيز .
كقوله تعالى : { قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ
الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِير(88) } الإسراء .
و قوله تعالى : { أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ
قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَ ادْعُوا مَنِ
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ(13) } هود .
و على هذا : فالضمير في مثله عائد إلى قوله تعالى
: { مِمَّا نَزَّلْنا } .
و يكون تعجيزا : بالقرآن نفسه ، و بداعة أسلوبه
، و بيانه .
و يمكن : أن يكون الضمير راجعا إلى قوله : { عَبْدِنا
} .
فيكون : تعجيزا بالقرآن من حيث ، إن الذي جاء به رجل
أمي ، لم يتعلم من معلم ، و لم يتلق شيئا من هذه المعارف الغالية العالية ، و
البيانات البديعة المتقنة ، من أحد من الناس .
فتكون الآية في مساق قوله تعالى :
{ قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لا أَدْراكُمْ بِهِ
فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ(16) } يونس .
و قد ورد : التفسيران معا ، في بعض الأخبار.
و اعلم : أن هذه الآية كنظائرها ، تعطي إعجاز أقصر
سورة من القرآن ، كسورة الكوثر ، و سورة العصر مثلا .
و ما ربما يحتمل : من رجوع ضمير { مثله } إلى نفس
السورة ، كسورة البقرة ، أو سورة يونس مثلا .
يأباه الفهم : المستأنس بأساليب الكلام ، إذ من يرمي
القرآن ، بأنه افتراء على الله تعالى ، إنما يرميه جميعا ، و لا يخصص قوله ذاك
بسورة دون سورة .
فلا معنى : لرده بالتحدي ، بسورة البقرة ، أو
بسورة يونس .
لرجوع : المعنى حينئذ ، إلى مثل قولنا :
و إن كنتم في ريب : من سورة الكوثر ، أو الإخلاص ، مثلا .
فأتوا بسورة : مثل سورة يونس ، و هو بين
الاستهجان ، هذا .
( بل المعنى : فأتوا بسورة من مثل سورة الكوثر أو مثل أي سورة أخرى في القرآن
الكريم ، لا فقط بمثل السور التي جاء فيها التحدي ) .
++++++++++++
الإعجاز و ماهيته : الكلام في الإعجاز و إعجاز القرآن :
( الإعجاز ثابت والقرآن بنفسه معجزة )
اعلم : أن دعوى القرآن
، أنها آية معجزة ، بهذا التحدي الذي أبدتها هذه الآية .
تنحل : بحسب الحقيقة ، إلى
دعويين ، و هما :
دعوى : ثبوت أصل
الإعجاز ، و خرق العادة الجارية .
و دعوى : أن القرآن
مصداق من مصاديق الإعجاز .
و معلوم : أن الدعوى الثانية ، تثبت بثبوتها الدعوى
الأولى .
و القرآن أيضا : يكتفي بهذا النمط من البيان ، و
يتحدى بنفسه .
فيستنتج به : كلتا النتيجتين .
غير أنه : يبقى الكلام على كيفية تحقق
الإعجاز .
مع اشتماله : على ما لا تصدقه العادة الجارية في
الطبيعة .
من استناد المسببات : إلى أسبابها المعهودة
المشخصة .
من غير استثناء : في حكم السببية ، أو تخلف و
اختلاف في قانون العلية .
و القرآن : يبين حقيقة
الأمر ، و يزيل الشبهة فيه .
فالقرآن : يشدق في بيان الأمر من
جهتين .
الأولى : أن الإعجاز ثابت ، و
من مصاديقه القرآن ، المثبت لأصل الإعجاز ، و لكونه منه بالتحدي .
الثانية : أنه ما هو حقيقة
الإعجاز ، و كيف يقع في الطبيعة أمر يخرق عادتها و ينقض كليتها .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص59 .
++
إعجاز القرآن :
( القرآن معجز بنفسه لعموم البشر بكل مستوياتهم ) :
لا ريب في أن القرآن : يتحدى بالإعجاز في آيات كثيرة مختلفة
، مكية و مدنية .
تدل جميعها
: على أن القرآن آية معجزة خارقة ، حتى أن الآية السابقة .
أعني قوله تعالى :{ وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِنْ مِثْلِه ... } الآية .
أي من مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم : استدلال على كون القرآن معجزة
، بالتحدي
على إتيان سورة نظيرة سورة من مثل النبي .
لا أنه استدلال : على النبوة مستقيما و
بلا واسطة .
و الدليل عليه قوله تعالى في أولها : { وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ
مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا } .
و لم يقل : و إن كنتم في ريب من رسالة عبدنا .
فجميع
التحديات : الواقعة في القرآن
، نحو استدلال على كون القرآن معجزة خارقة من عند الله .
و
الآيات المشتملة : على التحدي مختلفة في العموم و الخصوص
.
و من أعمها تحديا قوله تعالى
: { قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِير(88) } الإسراء ، و الآية مكية ، و فيها من عموم التحدي ، ما لا يرتاب فيه ذو مسكة .
فلو كان التحدي : ببلاغة بيان القرآن و جزالة أسلوبه فقط
.
لم يتعد التحدي : قوما خاصاين ، و
هم العرب العرباء من الجاهليين و المخضرمين ، قبل اختلاط اللسان و فساده .
و قد قرع
بالآية : أسماع الإنس و الجن .
و كذا غير : البلاغة و الجزالة
.
من كل صفة خاصة : اشتمل عليها القرآن .
كالمعارف :
الحقيقية ، و الأخلاق الفاضلة ، و
الأحكام التشريعية ، و الأخبار المغيبة
.
و معارف أخرى : لم
يكشف البشر حين النزول عن وجهها النقاب .
إلى غير ذلك : كل واحد منها مما يعرفه بعض
الثقلين ، دون جميعهم .
الميزان
في تفسير القرآن ج1ص60 .
فإطلاق التحدي : على
الثقلين ، ليس إلا في جميع ما يمكن فيه
التفاضل في الصفات .
فالقرآن : آية :
للبليغ : في بلاغته و فصاحته ، و
للحكيم في حكمته ، و للعالم في علمه
، و
للاجتماعي في اجتماعه، و للمقننين في تقنينهم
، و للسياسيين في سياستهم، و للحكام في
حكومتهم .
و لجميع العالمين : فيما لا ينالونه جميعا ،
كالغيب ، و الاختلاف في الحكم و
العلم و البيان.
و من هنا يظهر : أن القرآن يدعي عموم إعجازه من جميع الجهات
.
من حيث كونه : إعجازا لكل
فرد :
من الإنس : و الجن ، من عامة أو خاصة
، أو عالم أو جاهل ، أو رجل أو امرأة
، أو فاضل بارع
في فضله ، أو مفضول إذا كان ذا لب يشعر بالقول .
+++
( براهين وأدلة لإعجاز القرآن الكريم ) :
فإن الإنسان : مفطور على الشعور
بالفضيلة ، و إدراك الزيادة و النقيصة فيها .
فلكل إنسان : أن يتأمل ما يعرفه من الفضيلة
في نفسه ، أو في غيره من أهله .
ثم يقيس : ما أدركه منها إلى ما يشتمل عليه القرآن
، فيقضي
بالحق و النصفة .
فهل يتأتى : القوة البشرية
، أن يختلق معارف إلهية مبرهنة ، تقابل ما أتى به القرآن ، و تماثله في الحقيقة ؟
و هل يمكنها
: أن تأتي بأخلاق مبنية على أساس الحقائق
، تعادل ما أتى به القرآن في الصفاء و الفضيلة ؟
و هل يمكنها : أن يشرع أحكاما تامة فقهية
، تحصي جميع أعمال البشر ، من غير اختلاف يؤدي
إلى التناقض .
مع حفظ : روح التوحيد ، و كلمة التقوى ، في كل حكم و نتيجته ، و سريان الطهارة
في أصله و فرعه ؟
و هل يمكن : أن يصدر هذا الإحصاء العجيب
، و الإتقان الغريب .
من رجل أمي
: لم يترب إلا في حِجر قوم : حظهم من الإنسانية
، على مزاياها التي لا تحصى و كمالاتها
التي لا تغيا .
أن يرتزقوا : بالغارات و الغزوات ، و نهب الأموال
، و أن يئدوا البنات و
يقتلوا الأولاد خشية إملاق ، و يفتخروا بالآباء ، و ينكحوا الأمهات ، و يتباهوا بالفجور
، و
يذموا العلم ، و يتظاهروا بالجهل .
و هم على أنفتهم : و حميتهم الكاذبة ،
أذلاء لكل مستذل ، و
خطفة لكل خاطف ، فيوما لليمن ، و يوما للحبشة ، و يوما للروم ، و يوما للفرس ؟
فهذا حال : عرب
الحجاز في الجاهلية .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص61.
و هل يجتري عاقل
: على أن يأتي بكتاب يدعيه هدى للعالمين .
ثم يودعه : أخبارا في الغيب
مما مضى و يستقبل ، و فيمن خلت من الأمم ، و فيمن سيقدم منهم .
لا بالواحد و الاثنين : في
أبواب مختلفة ، من القصص ، و الملاحم ، و المغيبات المستقبلة .
ثم لا يتخلف : شيء منها عن
صراط الصدق ؟ .
و هل يتمكن
إنسان : و هو أحد أجزاء نشأة الطبيعة المادية
، و الدار دار التحول و
التكامل .
أن يداخل
: في كل شأن من شئون العالم الإنساني .
و يلقي : إلى الدنيا ، معارف
، و
علوما ، و قوانين ، و حكما ، و مواعظ ، و أمثالا ، و قصصا .
في كل ما دق و جل : ثم لا يختلف حاله
في شيء منها ، في الكمال و النقص .
و هي : متدرجة الوجود ، متفرقة الإلقاء ، و فيها ما ظهر
ثم تكرر ، و فيها فروع متفرعة على أصولها ؟
هذا مع ما نراه : أن كل إنسان ، لا يبقى من حيث
كمال العمل و نقصه ، على حال واحدة .
فالإنسان اللبيب : القادر على تعقل هذه المعاني ، لا يشك في أن هذه المزايا الكلية
، و
غيرها مما يشتمل عليه القرآن الشريف ، كلها فوق القوة البشرية ، و وراء الوسائل
الطبيعية المادية .
و إن لم يقدر : على ذلك ، فلم يضل في إنسانيته ، و لم ينس ما يحكم به
وجدانه الفطري ، أن يراجع فيما لا يحسن اختباره ، و يجهل مأخذه ، إلى أهل الخبرة به .
++
( فائدة عموم إعجاز القرآن العلمي لكل البشر في
كل زمان ومكان ) :
فإن قلت : ما الفائدة في
توسعة التحدي إلى العامة
، و التعدي عن حومة الخاصة
.
فإن
العامة : سريعة الانفعال للدعوة ، و الإجابة لكل صنيعة
، و قد خضعوا لأمثال الباب و
البهاء و القادياني و المسيلمة ، على أن ما أتوا به ، و استدلوا عليه أشبه بالهجر و
الهذيان منه بالكلام ؟
قلت : هذا هو السبيل في عموم الإعجاز
، و الطريق الممكن في تمييز الكمال و التقدم ، في
أمر يقع فيه التفاضل و السباق .
فإن أفهام الناس : مختلفة اختلافا ضروريا ، و
الكمالات :
كذلك .
و النتيجة الضرورية : لهاتين المقدمتين
:
أن يدرك : صاحب الفهم العالي ، و النظر
الصائب .
و يرجع : من هو دون ذلك فهما و نظرا إلى صاحبه .
و الفطرة : حاكمة ، و الغريزة
قاضية .
و لا يقبل شيء : مما يناله الإنسان ، بقواه المدركة
، و يبلغه فهمه ، العموم و الشمول لكل
فرد ، في كل زمان و مكان ، بالوصول و البلوغ و البقاء .
إلا ما هو : من سنخ العلم و المعرفة ،
على الطريقة المذكورة .
فإن كل ما فرض : آية معجزة ، غير العلم و المعرفة
، فإنما هو موجود
طبيعي ، أو حادث حسي .
محكوم : بقوانين المادة ، محدود بالزمان و المكان .
فليس بمشهود : إلا
لبعض أفراد الإنسان دون بعض .
و لو فرض : محالا أو كالمحال ، عمومه لكل فرد منه ، فإنما
يمكن في مكان دون جميع الأمكنة ، و لو فرض
اتساعه لكل مكان ، لم يمكن
اتساعه لجميع
الأزمنة و الأوقات .
فهذا : ما تحدى به القرآن
، تحديا عاما ، لكل فرد ، في كل مكان في كل زمان.
الميزان في تفسير القرآن ج1ص62.
++++
( القسم الثالث في بيان : إعجاز القرآن ، وحقائقه الكريمة الشريفة ، ومعانية العالية المنيفة ، في تفسير
الآية 23 من سورة البقرة ، وبعد أن عرفنا تفسير الآيات السابقة و حتى الآية 25
ومعانيها ، وحقيقة أن القرآن الكريم يثبت وقوع الإعجاز في التكوين بأسبابه وأن
القرآن الكريم معجزة بنفسه ، ويتحدى الإتيان بمثله أو بمثل أي من سوره وآياته ،
والتحدي لعموم الإنس والجن بكل طوائفهم وطبقاتهم ولغاتهم ، والآن البحث في أنواع
تحديه وأولها : التحدي بالعلم ، والثاني : بمن أنزل عليه ، والثالث : الإخبار
بالغيب ، والرابع : بعدم الاختلاف فيه :)
تحديه ( القرآن ) بالعلم ( وثباته وشموله على
أساس الفطرة والتوحيد ):
و قد تحدى ( القرآن ) : بالعلم و المعرفة خاصة .
بقوله تعالى : { وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ
تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ (89) } النحل .
و قوله : { وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ
إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ(59) } الأنعام .
إلى غير ذلك : من الآيات .
فإن الإسلام
: كما يعلمه و يعرفه كل من سار في متن تعليماته ، من كلياته التي أعطاها القرآن
، و
جزئياته التي أرجعها إلى النبي صلى الله عليه وآله .
بنحو قوله : { ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ
ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (7) } الحشر .
و قوله تعالى : { لِتَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ (104) } النساء، و غير ذلك .
متعرض : للجليل و الدقيق :
من
المعارف : الإلهية الفلسفية ، و الأخلاق الفاضلة .
و القوانين الدينية الفرعية : من
عبادات ، و معاملات ، و سياسات ، و اجتماعيات ، و كل ما يمسه فعل الإنسان و عمله .
كل ذلك
: على أساس الفطرة ، و أصل التوحيد ، بحيث ترجع التفاصيل إلى أصل التوحيد بالتحليل ، و
يرجع الأصل إلى التفاصيل بالتركيب .
و قد بين بقاؤها جميعا : و انطباقها على صلاح الإنسان
، بمرور الدهور و كرورها .
بقوله
تعالى : { وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ(42) } حم سجدة.
و
قوله تعالى : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ(9)
} الحجر.
فهو كتاب : لا يحكم عليه حاكم النسخ ، لا يقضي عليه قانون التحول و
التكامل .
الميزان
في تفسير القرآن ج1ص63.
( التشريع ينمو في التكوين على أساس التوحيد
والفطرة لا المادة والزمان ) :
فإن قلت : قد استقرت أنظار الباحثين عن الاجتماع و علماء التقنين اليوم
، على
وجوب تحول القوانين الوضعية الاجتماعية بتحول الاجتماع ، و اختلافها باختلاف الأزمنة
و الأوقات ، و تقدم المدنية و الحضارة .
قلت : سيجيء البحث عن هذا الشأن .
و الجواب عن الشبهة : في تفسير قوله تعالى : { كانَ
النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً .....الآية (213) } البقرة .
و جملة القول و ملخصه :
أن القرآن : يبني أساس التشريع على التوحيد الفطري
، و الأخلاق
الفاضلة الغريزية .
و يدعي : أن التشريع يجب أن ينمو ، من بذر التكوين و الوجود .
و هؤلاء الباحثون : يبنون نظرهم على تحول الاجتماع ، مع إلغاء المعنويات من معارف
التوحيد و فضائل الأخلاق .
فكلمتهم : جامدة على سير التكامل الاجتماعي المادي ، العادم
لفضيلة الروح ، و كلمة الله هي العليا .
++++
التحدي بمن أنزل عليه القرآن :
و قد تحدى ( القرآن ) :
بالنبي الأمي .
الذي : جاء بالقرآن المعجز في لفظه و معناه ، و لم يتعلم عند
معلم ، و لم يترب عند مرب .
بقوله تعالى : { قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ
عَلَيْكُمْ وَ لا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ
أَ فَلا تَعْقِلُونَ(16) } يونس .
فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم : بينهم ، و هو أحدهم ، لا يتسامى في فضل ، و
لا ينطق بعلم ، حتى لم يأت بشيء من شعر أو نثر ، نحوا من أربعين سنة ، و هو ثلثا عمره
، لا
يحوز تقدما ، و لا يرد عظيمة من عظائم المعالي .
ثم أتى بما أتى به : دفعة ، فأتى بما عجزت
عنه فحولهم ، و كلت دونه ألسنة بلغائهم .
ثم بثه : في أقطار الأرض ، فلم يجترئ على معارضته
معارض ، من عالم أو فاضل ، أو ذي لب و فطانة.
و غاية ما أخذوه عليه : أنه سافر إلى الشام للتجارة ، فتعلم هذه القصص ممن هناك من
الرهبان .
و لم تكن أسفاره : إلى الشام ، إلا مع عمه أبي طالب قبل بلوغه ، و إلا مع ميسرة
مولى خديجة ، و سنه يومئذ خمسة و عشرون ، و هو مع من يلازمه في ليله و نهاره .
و لو فرض
: محالا ذلك :
فما : هذه المعارف و العلوم ؟
و من أين : هذه الحكم و الحقائق ؟
و ممن : هذه
البلاغة في البيان ، الذي خضعت لها الرقاب ، و كلت دونها الألسن الفصاح ؟.
الميزان في
تفسير القرآن ج1ص64 .
و ما أخذوه عليه : أنه كان يقف على قين بمكة من أهل الروم ، كان يعمل السيوف
و يبيعها .
فأنزل الله سبحانه : { وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما
يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ
عَرَبِيٌّ مُبِينٌ(103) } النحل .
و ما قالوا عليه : أنه يتعلم بعض ما يتعلم من سلمان الفارسي ، و هو من علماء الفرس
، عالم
بالمذاهب و الأديان .
مع أن سلمان : إنما آمن به في المدينة ، و قد نزل أكثر القرآن بمكة
، و فيه من جميع المعارف الكلية و القصص ، وأزيد مما نزل منها في المدينة ، فما الذي زاده
إيمان سلمان و صحابته ؟
على أن من قرأ العهدين :
و تأمل ما فيهما ، ثم رجع إلى ما قصه القرآن من تواريخ
الأنبياء السالفين و أممهم .
رأى أن : التاريخ غير التاريخ ، و القصة غير القصة .
ففيهما :
عثرات و خطايا لأنبياء الله الصالحين ، تنبو الفطرة و تتنفر من أن تنسبها إلى
المتعارف من صلحاء الناس و عقلائهم .
و القرآن : يبرئهم منها .
و فيها أمور أخرى : لا
يتعلق بها معرفة حقيقية ، و لا فضيلة خلقية .
و لم يذكر القرآن منها : إلا ما ينفع الناس
في معارفهم و أخلاقهم ، و ترك الباقي و هو الأكثر.
++++
تحدي القرآن بالإخبار عن الغيب :
و قد تحدى ( القرآن ) : بالإخبار عن الغيب ، بآيات كثيرة :
منها : إخباره بقصص الأنبياء السالفين و
أممهم .
كقوله تعالى : { تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ
تَعْلَمُها أَنْتَ وَ لا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا..(49) } هود .
و قوله تعالى
بعد قصة يوسف : { ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ(102) } يوسف.
و قوله
تعالى في قصة مريم : { ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ(44) } آل عمران .
و قوله تعالى : { ذلِكَ عِيسَى
ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ(34) } مريم ، إلى غير
ذلك من الآيات.
الميزان
في تفسير القرآن ج1ص65.
و منها : الإخبار عن الحوادث المستقبلة :
كقوله تعالى : { غُلِبَتِ الرُّومُ فِي
أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ
سِنِينَ(2، 3) } الروم .
و قوله تعالى في رجوع النبي إلى مكة بعد الهجرة : { إِنَّ
الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ(85) } القصص .
و قوله تعالى : { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ» الآية: الفتح- 27.
و قوله
تعالى : { سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ
لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ(15) } الفتح .
و قوله تعالى : { وَ اللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ(70) } المائدة .
و قوله تعالى : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ(9) } الحجر .
و آيات أخر كثيرة : في وعد
المؤمنين ، و وعيد كفار مكة و مشركيها .
و من هذا الباب : آيات أخر في الملاحم نظير :
قوله تعالى : { وَ حَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ
أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ
مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ
فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي
غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ( 95، 97) } الأنبياء .
و قوله تعالى : {
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ(55) } النور.
و قوله تعالى : { قُلْ هُوَ
الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ(65) } الأنعام .
و من هذا الباب :
قوله تعالى : { وَ أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ (22) } الحجر
.
و قوله تعالى : { وَ أَنْبَتْنا
فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ(19) } الحجر .
و قوله تعالى : { وَ الْجِبالَ
أَوْتاد(7) } النبأ .
مما يبتني : حقيقة القول فيها ، على حقائق علمية مجهولة عند
النزول ، حتى اكتشف الغطاء عن وجهها ، بالأبحاث العلمية التي وفق الإنسان لها في هذه الأعصار .
و من هذا الباب : و هو من مختصات هذا التفسير .
الباحث : عن آيات القرآن ، باستنطاق بعضها
ببعض ، و استشهاد بعضها على بعض :
ما في سورة المائدة من قوله تعالى :
{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ
يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ .......(54) الآية } المائدة
.
و ما
في سورة يونس من قوله تعالى : { وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ
رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ....... (47) إلى آخر الآيات } يونس .
و ما في
سورة الروم من قوله تعالى : { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ
اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ..... (30) الآية } الروم.
إلى غير ذلك : من
الآيات التي تنبئ عن الحوادث العظيمة ، التي تستقبل الأمة الإسلامية ، أو الدنيا عامة
بعد عهد نزول القرآن .
و سنورد : إن شاء الله تعالى ، طرفا منها في البحث عن سورة
الإسراء .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص66 .
+++
تحدى القرآن بعدم الاختلاف فيه :
و قد تحدى أيضا : بعدم وجود الاختلاف فيه :
قال تعالى : { أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ
الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً
كَثِير(82) } النساء .
فإن من الضروري : أن النشأة نشأة المادة ، و القانون الحاكم
فيها ، قانون التحول و التكامل .
فما من موجود : من الموجودات التي هي أجزاء هذا العالم ، إلا و هو متدرج الوجود ، متوجه من الضعف إلى القوة
، و من النقص إلى الكمال في ذاته ، و
جميع توابع ذاته ، و لواحقه من الأفعال و الآثار .
و من جملتها : الإنسان ، الذي لا يزال
يتحول و يتكامل في وجوده و أفعاله ، و آثاره ، التي منها آثاره التي يتوسل إليها بالفكر
و الإدراك .
فما من واحد منا : إلا و هو يرى نفسه كل يوم أكمل من أمس ، و لا يزال يعثر
في الحين الثاني على سقطات في أفعاله ، و عثرات في أقواله الصادرة منه في الحين
الأول ، هذا أمر لا ينكره من نفسه إنسان ذو شعور .
و هذا الكتاب : جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، نجوما .
و قرأه على الناس : قطعا قطعا ، في مدة ثلاث و عشرين
سنة .
في أحوال مختلفة : و شرائط متفاوتة ، في مكة و المدينة ، في الليل و النهار ، و الحضر و
السفر ، و الحرب و السلم ، في يوم العسرة و في يوم الغلبة ، و يوم الأمن و يوم الخوف
.
و
لإلقاء : المعارف الإلهية ، و تعليم الأخلاق الفاضلة ، و تقنين الأحكام الدينية ، في جميع
أبواب الحاجة .
و لا يوجد فيه : أدنى اختلاف في النظم المتشابه ، كتابا متشابها مثاني .
و
لم يقع : في المعارف التي ألقاها ، و الأصول التي أعطاها .
اختلاف : يتناقض ، بعضها مع بعض ، و
تنافي شيء منها مع آخر .
فالآية تفسر : الآية ، و البعض يبين البعض ، و الجملة تصدق
الجملة .
كما
قال علي عليه السلام : ينطق بعضه ببعض ، و يشهد بعضه على بعض .
نهج البلاغة ص191خ133 .
و لو كان : من عند غير الله ، لاختلف النظم في الحسن و البهاء ، و القول في الشداقة و
البلاغة ، و المعنى من حيث الفساد و الصحة ، و من حيث الإتقان و المتانة .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص67
فإن قلت : هذه مجرد دعوى لا تتكي على دليل
، و قد أخذ على القرآن مناقضات و إشكالات
جمة ، ربما ألف فيه التأليفات .
و هي إشكالات لفظية : ترجع إلى قصوره في جهات البلاغة ، و
مناقضات معنوية تعود إلى خطئه في آرائه و أنظاره و تعليماته .
و قد
أجاب عنها المسلمون : بما لا يرجع في الحقيقة إلا إلى التأويلات ، التي يحترزها الكلام
الجاري على سنن الاستقامة ، و ارتضاء الفطرة السليمة .
قلت : ما أشير إليه من المناقضات و الإشكالات ، موجودة في كتب التفسير و غيرها مع
أجوبتها .
و منها : هذا الكتاب .
فالإشكال : أقرب إلى الدعوى الخالية عن البيان .
و لا تكاد : تجد في هذه المؤلفات التي ذكرها المستشكل ، شبهة أوردوها ، أو مناقضة أخذوها
، إلا و هي مذكورة في مسفورات المفسرين مع أجوبتها ، فأخذوا الإشكالات و جمعوها و
رتبوها ، و تركوا الأجوبة و أهملوها .
و نعم ما قيل : لو كانت عين الحب متهمة ، فعين
البغض أولى بالتهمة .
فإن قلت : فما تقول : في النسخ الواقع في القرآن :
و قد نص عليه القرآن نفسه في قوله :
{ ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْه(106) } البقرة
.
و
قوله : { وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ (101)
} النحل .
و هل النسخ : إلا اختلاف في النظر ، لو سلمنا أنه ليس من قبيل المناقضة
في القول ؟
قلت : النسخ كما أنه ليس من المناقضة في القول ، و هو ظاهر كذلك ليس من قبيل الاختلاف
في النظر و الحكم .
و إنما هو : ناش من الاختلاف في المصداق ، من حيث قبوله انطباق الحكم
يوما ، لوجود مصلحته فيه ، و عدم قبوله الانطباق يوما آخر ، لتبدل المصلحة من مصلحة أخرى
، توجب حكما آخر .
و من أوضع الشهود : على هذا أن الآيات المنسوخة الأحكام في القرآن
، مقترنة بقرائن لفظية ، تومئ إلى أن الحكم المذكور في الآية سينسخ .
كقوله تعالى : { وَ
اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلً(14) } النساء ، انظر إلى التلويح الذي تعطيه الجملة الأخيرة
.
و كقوله تعالى : { وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ
كُفَّارا..... إلى أن قال .. فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِهِ ( 109) } البقرة ، حيث تمم الكلام بما يشعر بأن الحكم مؤجل .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص68 .
=++++=
( القسم الرابع : في بيان إعجاز القرآن : من تفسير الآية : 23 من سورة البقرة ،
وهو نوع التحدي الخامس : في تحديه بالبلاغة ، بعد أن عرفنا : تحديه بالعلم ، وبمن
أنزل عليه ، وبالإخبار بالغيب ، وبعدم الاختلاف فيه ، وقد عرفنا في مقدمة إعجاز
القرآن ، إمكانه وثبوته وفق السنن الكونية .)
التحدي بالبلاغة : ( وحقيقتها وبيان الإشكالات على بلاغة القرآن
وجوابها ) :
و قد تحدى القرآن بالبلاغة :
كقوله تعالى : { أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ
فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(13، 14) } هود ،
و الآية مكية .
و قوله تعالى : { أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ
تَأْوِيلُهُ(38، 39) } يونس ، و الآية أيضا مكية .
و فيها التحدي : بالنظم و البلاغة
، فإن ذلك هو الشأن الظاهر من شئون العرب المخاطبين بالآيات يومئذ .
فالتاريخ : لا يرتاب
في أن العرب العرباء ، بلغت من البلاغة في الكلام ، مبلغا لم يذكره التاريخ لواحدة من
الأمم المتقدمة عليهم و المتأخرة عنهم ، و وطئوا موطئا لم تطأه أقدام غيرهم ، في كمال
البيان و جزالة النظم ، و وفاء اللفظ ، و رعاية المقام ، و سهولة المنطق .
و قد تحدى عليهم
القرآن : بكل تحد ممكن ، مما يثير الحمية ، و يوقد نار الأنفة و العصبية .
و حالهم في
الغرور : ببضاعتهم ، و الاستكبار عن الخضوع للغير في صناعتهم ، مما لا يرتاب فيه .
و قد
طالت : مدة التحدي ، و تمادى زمان الاستنهاض ، فلم يجيبوه إلا بالتجافي ، و لم يزدهم إلا
العجز ، و لم يكن منهم إلا الاستخفاء و الفرار .
كما قال تعالى : { أَلا إِنَّهُمْ
يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ
يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ(5) } هود .
و قد مضى : من القرون و الأحقاب ، ما يبلغ أربعة عشر قرنا
.
و لم يأت : بما يناظره آت
، و لم
يعارضه أحد بشيء ، إلا أخزى نفسه و افتضح في أمره .
و قد ضبط النقل : بعض هذه المعارضات و المناقشات .
فهذا مسيلمة : عارض سورة الفيل بقوله :
« الفيل ما الفيل و ما أدريك ما الفيل له ذنب وبيل و خرطوم طويل » .
و في كلام له في
الوحي يخاطب السجاح النبية : « فنولجه فيكن إيلاجا، و نخرجه منكن إخراجا » .
فانظر : إلى
هذه الهذيانات و اعتبر .
و هذه سورة عارض بها الفاتحة بعض النصارى : « الحمد للرحمن. رب
الأكوان الملك الديان . لك العبادة و بك المستعان أهدنا صراط الإيمان » .
إلى غير ذلك
من التقولات .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص69 .
++
فإن قلت :
ما معنى كون التأليف الكلامي ، بالغا إلى مرتبة معجزة للإنسان ، و وضع الكلام
مما سمحت به قريحة الإنسان ؟
فكيف يمكن : أن يترشح من القريحة ما لا تحيط به ، و الفاعل
أقوى من فعله ، و منشأ الأثر محيط بأثره ؟
و بتقريب آخر : الإنسان هو الذي جعل اللفظ
علامة دالة على المعنى ، لضرورة الحاجة الاجتماعية إلى تفهيم الإنسان ما في ضميره
لغيره ، فخاصة الكشف عن المعنى في اللفظ ، خاصة وضعية اعتبارية مجعولة للإنسان .
و من
المحال : أن يتجاوز هذه الخاصة المترشحة عن قريحة الإنسان حد قريحته ، فتبلغ مبلغا لا
تسعه طاقة القريحة .
فمن المحال حينئذ : أن يتحقق في اللفظ نوع من الكشف ، لا تحيط به
القريحة ، و إلا كانت غير الدلالة الوضعية الاعتبارية .
+
مضافا إلى أن : التراكيب
الكلامية ، لو فرض أن بينها تركيبا بالغا حد الإعجاز .
كان معناه : أن كل معنى من المعاني
المقصودة ، ذو تراكيب كلامية مختلفة في النقص و الكمال ، و البلاغة و غيرها .
و بين تلك
التراكيب : تركيب هو أرقاها و أبلغها ، لا تسعها طاقة البشر ، و هو التركيب المعجز
.
و
لازمه : أن يكون في كل معنى مطلوب ، تركيب واحد إعجازي .
مع أن القرآن : كثيرا ما يورد في المعنى الواحد ،
بيانات مختلفة ، و تراكيب متفرقة ، و هو في القصص واضح لا ينكر .
و لو كانت : تراكيبه معجزة ، لم يوجد منها في كل معنى مقصود
إلا واحد لا غير !
+++
قلت : هاتان الشبهتان ، و ما شاكلهما .
هي الموجبة : لجمع من الباحثين في إعجاز القرآن في
بلاغته .
أن يقولوا : بالصرف .
و معنى الصرف : أن الإتيان بمثل القرآن ، أو سور ، أو سورة
واحدة منه ، محال على البشر ، لمكان آيات التحدي ، و ظهور العجز من أعداء القرآن منذ
قرون .
و لكن لا لكون : التأليفات الكلامية ، التي فيها في نفسها خارجة عن طاقة الإنسان
، و فائقة على القوة البشرية ، مع كون التأليفات جميعا أمثالا لنوع النظم الممكن
للإنسان .
بل لأن الله سبحانه : يصرف الإنسان عن معارضتها ، و الإتيان بمثلها ، بالإرادة
الإلهية ، الحاكمة على إرادة الإنسان ، حفظا لآية النبوة ، و وقاية لحمى الرسالة .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص70 .
و هذا قول : فاسد
، لا ينطبق على ما يدل عليه آيات التحدي بظاهرها .
كقوله : { قُلْ فَأْتُوا
بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا
أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ... (13 14) الآية } هود .
فإن الجملة الأخيرة : ظاهرة
في أن ، الاستدلال بالتحدي ، إنما هو على كون القرآن نازلا ، لا كلاما تقوله رسول الله
،
و أن نزوله إنما هو بعلم الله ، لا بإنزال الشياطين .
كما قال تعالى : { أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا
بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ(34) } الطور .
و قوله تعالى : { وَ ما
تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ وَ ما يَنْبَغِي لَهُمْ وَ ما يَسْتَطِيعُونَ
إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ(212) } الشعراء .
و الصرف : الذي يقولون به .
إنما يدل : على صدق الرسالة بوجود آية هي الصرف ، لا على كون القرآن كلاما لله نازلا
من عنده .
و نظير هذه الآية : الآية الأخرى ، و هي قوله : { قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ
تَأْوِيلُهُ .. (39) الآية } يونس .
فإنها ظاهرة : في أن الذي يوجب استحالة إتيان البشر
بمثل القرآن ، و ضعف قواهم ، و قوى كل من يعينهم على ذلك ، من تحمل هذا الشأن ، هو أن
للقرآن تأويلا لم يحيطوا بعلمه ، فكذبوه ، و لا يحيط به علما إلا الله فهو الذي يمنع
المعارض عن أن يعارضه ، لا أن الله سبحانه يصرفهم عن ذلك ، مع تمكنهم منه لو لا الصرف
بإرادة من الله تعالى.
و كذا قوله تعالى : { أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً .... (82) الآية } النساء.
فإنه
ظاهر : في أن الذي يعجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن ، إنما هو كونه في نفسه على صفة
عدم الاختلاف لفظا و معنى ، و لا يسع لمخلوق أن يأتي بكلام غير مشتمل على الاختلاف ،
لا أن الله صرفهم عن مناقضته بإظهار الاختلاف الذي فيه ، هذا .
فما ذكروه : من أن إعجاز
القرآن بالصرف كلام ، لا ينبغي الركون إليه .
+++
و أما الإشكال : باستلزام الإعجاز من حيث البلاغة المحال :
بتقريب : أن البلاغة من صفات
الكلام الموضوع ، و وضع الكلام من آثار القريحة الإنسانية ، فلا يمكن أن يبلغ من الكمال
حدا لا تسعه طاقة القريحة ، و هو مع ذلك معلول لها لا لغيرها .
فالجواب عنه
:
أن الذي يستند من الكلام : إلى قريحة
الإنسان ، إنما هو كشف اللفظ المفرد عن معناه .
و أما سرد
الكلام : و نضد الجمل ، بحيث يحاكي جمال المعنى المؤلف
، و هيئته على ما هو عليه في الذهن
بطبعه ، حكاية تامة أو ناقصة ، و إرائة واضحة أو خفية .
و كذا تنظيم : الصورة العلمية في
الذهن ، بحيث يوافق الواقع في جميع روابطه و مقدماته ، و مقارناته و لواحقه ، أو في كثير
منها ، أو في بعضها دون بعض .
فإنما هو : أمر لا يرجع إلى وضع الألفاظ ، بل إلى نوع مهارة
في صناعة البيان ، و فن البلاغة .
تسمح به القريحة : في سرد الألفاظ و نظم
الأدوات اللفظية ، و نوع لطف في الذهن .
يحيط به : القوة الذاهنة على الواقعة ، المحكية
بأطرافها و لوازمها و متعلقاتها.
الميزان في
تفسير القرآن ج1ص71.
فهاهنا جهات ثلاث :
يمكن : أن تجتمع في الوجود أو تفترق .
فربما : أحاط إنسان بلغة من
اللغات ، فلا يشذ عن علمه لفظ ، لكنه لا يقدر على التهجي و التكلم .
و ربما : تمهّر الإنسان
في البيان و سرد الكلام ، لكن لا علم له بالمعارف و المطالب ، فيعجز عن التكلم فيها
بكلام حافظ لجهات المعنى ، حاك لجمال صورته التي هو عليها في نفسه .
و ربما : تبحر
الإنسان في سلسلة من المعارف و المعلومات ، و لطفت قريحته ، و رقت فطرته ، لكن لا يقدر
على الإفصاح عن ما في ضميره ، و عي عن حكاية ما يشاهده من جمال المعنى و منظره
البهيج .
فهذه أمور ثلاثة :
أولها : راجع إلى وضع الإنسان بقريحته الاجتماعية .
و الثاني و
الثالث : راجعان إلى نوع من لطف القوة المدركة .
و من البين : أن إدراك القوى المدركة
منا ، محدودة مقدرة ، لا نقدر على الإحاطة بتفاصيل الحوادث الخارجية ، و الأمور الواقعية
، بجميع روابطها .
فلسنا على أمن : من الخطأ قط ، في وقت من الأوقات .
و مع ذلك : فالاستكمال
التدريجي الذي في وجودنا ، أيضا يوجب الاختلاف التدريجي في معلوماتنا ، أخذا من النقص
إلى الكمال .
فأي خطيب : أشدق ، و أي شاعر مفلق ، فرضته ، لم يكن ما يأتيه في أول أمره
، موازنا لما تسمح به قريحته في أواخر أمره .
فلو فرضنا : كلاما إنسانيا ، أي كلام فرضناه
، لم يكن في مأمن من الخطأ ، لفرض عدم اطلاع متكلمه بجميع أجزاء الواقع و شرائطه
، أولا.
و لم يكن : على حد كلامه السابق ، و لا على زنة كلامه اللاحق ، بل و لا أوله يساوي آخره
، و
إن لم نشعر بذلك لدقة الأمر ، لكن حكم التحول و التكامل عام ، ثانيا .
و على هذا : فلو
عثرنا على كلام فصل لا هزل فيه ـ و جد الهزل : هو القول بغير علم محيط ـ و لا اختلاف
يعتريه ، لم يكن كلاما بشريا .
و هو الذي يفيده القرآن بقوله : { أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ
الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً
كَثِيراً ....(82) الآية } النساء.
و قوله تعالى : { وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ وَ
الْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ .....
(14) }
الطارق .
انظر : إلى موضع القسم بالسماء و الأرض المتغيرتين ، و المعنى المقسم به في
عدم تغيره ، و اتكاءه على حقيقة ثابتة ، هي تأويله ، و سيأتي ما يراد في القرآن من لفظ
التأويل .
و قوله تعالى : { بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ
(22) }
البروج .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص72 .
و قوله تعالى : { وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ، إِنَّا جَعَلْناهُ
قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ
لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ(4) } الزخرف.
و قوله تعالى : { فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ
(75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
(77) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (78) لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)
تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (80)} الواقعة .
فهذه الآيات و نظائرها : تحكي عن اتكاء القرآن في
معانيه على حقائق ثابتة ، غير متغيرة و لا متغير ما يتكي عليها .
إذا عرفت ما مر : علمت أن استناد وضع اللغة إلى الإنسان ، لا يقتضي أن لا يوجد تأليف
كلامي فوق ما يقدر عليه الإنسان الواضع له .
و ليس ذلك إلا كالقول : بأن القين الصانع
للسيوف ؛ يجب أن يكون أشجع من يستعملها ، و واضع النرد و الشطرنج
؛ يجب أن يكون أمهر من
يلعب بهما ، و مخترع العود ؛ يجب أن يكون أقوى من يضرب بها .
فقد تبين من ذلك كله : أن البلاغة التامة ، معتمدة على نوع من العلم المطابق للواقع
، من
جهة مطابقة اللفظ للمعنى ، و من جهة مطابقة المعنى المعقول للخارج الذي يحكيه الصورة
الذهنية.
أما اللفظ : فأن يكون الترتيب الذي بين أجزاء اللفظ بحسب الوضع
،مطابقا للترتيب الذي
بين أجزاء المعنى المعبر عنه باللفظ بحسب الطبع ، فيطابق الوضع الطبع
، كما قال الشيخ
عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز.
و أما المعنى : فأن يكون في صحته و صدقه ، معتمدا على الخارج الواقع
، بحيث لا يزول عما
هو عليه من الحقيقة ، و هذه المرتبة هي التي يتكي عليها المرتبة السابقة .
فكم من هزل
: بليغ في هزليته ، لكنه لا يقاوم الجد .
و كم من كلام بليغ : مبني على الجهالة ، لكنه لا
يعارض و لا يسعه أن يعارض الحكمة .
و الكلام : الجامع بين عذوبة اللفظ ، و جزالة الأسلوب
، و بلاغة المعنى ، و حقيقة الواقع ، هو أرقى الكلام .
و إذا كان الكلام : قائما على أساس الحقيقة ، و منطبق المعنى عليها تمام الانطباق
، لم
يكذب الحقائق الآخر و لم تكذبه .
فإن الحق : مؤتلف الأجزاء ، و متحد الأركان ، لا يبطل حق
حقا ، و لا يكذب صدق صدقا .
و الباطل : هو الذي ينافي الباطل ، و ينافي الحق .
أنظر : إلى
مغزى ، قوله سبحانه و تعالى : { فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ(32) } يونس.
فقد جعل الحق : واحدا لا تفرق فيه و لا تشتت .
و انظر إلى قوله تعالى : { وَ لا
تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ (153) } الأنعام .
فقد جعل : الباطل ، متشتتا و مشتتا ، و متفرقا و مفرقا.
الميزان في تفسير القرآن ج1ص73 .
و إذا كان الأمر كذلك :
فلا يقع : بين أجزاء الحق اختلاف ، بل نهاية الائتلاف
.
يجر : بعضه
إلى بعض .
و ينتج : بعضه البعض .
كما يشهد : بعضه على بعض .
و يحكي : بعضه البعض .
و هذا من عجيب أمر القرآن : فإن الآية من آياته ، لا تكاد تصمت عن الدلالة ، و لا تعقم عن
الإنتاج .
كلما ضمت : آية إلى آية مناسبة ، أنتجت حقيقة من أبكار الحقائق ، ثم الآية
الثالثة تصدقها و تشهد بها ، هذا شأنه و خاصته .
و سترى : في خلال البيانات في هذا
الكتاب ، نبذا من ذلك ، على أن الطريق متروك غير مسلوك ، و لو أن المفسرين ساروا هذا
المسير ، لظهر لنا إلى اليوم ينابيع من بحاره العذبة ، و خزائن من أثقاله النفيسة .
فقد اتضح : بطلان الإشكال من الجهتين جميعا .
فإن أمر البلاغة المعجزة : لا يدور مدار
اللفظ .
حتى يقال : إن الإنسان هو الواضع للكلام ، فكيف لا يقدر على أبلغ الكلام و أفصحه
؟ و هو واضح .
أو يقال : إن أبلغ التركيبات المتصورة ، تركيب واحد
من بينها ، فكيف يمكن التعبير عن معنى واحد ، بتركيبات متعددة ، مختلفة السياق ، و
الجميع فائقة قدرة البشر ، بالغة حد الإعجاز ؟
بل المدار : هو المعنى المحافظ ، لجميع جهات الذهن و الخارج .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص74 .
====+++++====
( القسم الخامس : في بيان إعجاز القرآن وتحقق ما يخرق العادة ، بتصرف عالم
الغيب وما وراء الطبيعة ، في عالم المادة والشهادة ، وفق قانون العلية والأسباب
المخفية علينا ، مع التحدي بأمر إلهي غير مغلوب ، فيصدق قدرة وعظم المرسل والرسول
والرسالة ، في تفسير الآية 23 من سورة البقرة ، بعد أن عرفنا تحدي القرآن ،
بالبلاغة ، والعلم ، وبمن أنزل عليه ، وبالإخبار بالغيب ، وعدم الاختلاف فيه ) .
معنى الآية المعجزة في القرآن و ما يفسر به
حقيقتها :
و لا شبهة : في دلالة القرآن على ثبوت الآية المعجزة و تحققها .
بمعنى : الأمر الخارق
للعادة ، الدال على تصرف ما وراء الطبيعة ، في عالم الطبيعة و نشأة المادة.
لا بمعنى
: الأمر المبطل ، لضرورة العقل .
و ما تمحله : بعض المنتسبين إلى العلم ، من تأويل الآيات الدالة على ذلك
.
توفيقا : بينها ، و
بين ما يتراءى من ظواهر الأبحاث الطبيعية العلمية اليوم.
تكلف : مردود إليه .
و الذي يفيده القرآن الشريف : في معنى خارق العادة ، و إعطاء حقيقته .
نذكره في فصول من الكلام :
1 - تصديق القرآن لقانون العلية العامة :
إن القرآن : يثبت للحوادث الطبيعية أسبابا ، و يصدق قانون العلية العامة .
كما يثبته
: ضرورة العقل ، و تعتمد عليه الأبحاث العلمية ، و الأنظار الاستدلالية .
فإن الإنسان
: مفطور على أن يعتقد لكل حادث مادي ، علة موجبة ، من غير تردد و ارتياب .
و كذلك العلوم
الطبيعية : و سائر الأبحاث العلمية ، تعلل الحوادث ، و الأمور المربوطة بما تجده من أمور
أخرى صالحة للتعليل .
و لا نعني بالعلة : إلا أن يكون هناك أمر واحد ، أو مجموع أمور ، إذا
تحققت في الطبيعة مثلا ، تحقق عندها أمر آخر ، نسميه المعلول ، بحكم التجارب .
كدلالة
التجربة : على أنه كلما تحقق احتراق ، لزم أن يتحقق هناك قبله علة موجبة له ، من نار
، أو
حركة ، أو اصطكاك ، أو نحو ذلك .
و من هنا كانت : الكلية ، و عدم التخلف ، من أحكام العلية و المعلولية و لوازمهما.
و تصديق هذا المعنى : ظاهر من القرآن ، فيما جرى عليه ، و تكلم فيه ، من موت ، و حياة
، و رزق ، و
حوادث أخرى ، علوية سماوية ، أو سفلية أرضية ، على أظهر وجه ، و إن كان يسندها جميعا
بالآخرة إلى الله سبحانه ، لفرض التوحيد .
فالقرآن : يحكم بصحة قانون العلية العامة .
بمعنى : أن سببا من الأسباب ، إذا تحقق مع ما
يلزمه و يكتنف به من شرائط التأثير ، من غير مانع ؛ لزمه وجود مسببه مترتبا عليه بإذن
الله سبحانه .
و إذا وجد المُسبَب : كشف ذلك عن تحقق سببه لا محالة .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص75 .
+++
2 - إثبات القرآن ما يخرق العادة :
ثم إن القرآن : يقتص و يخبر عن جملة من الحوادث و الوقائع ، لا يساعد عليه جريان
العادة المشهودة في عالم الطبيعة ، على نظام العلة و المعلول الموجود .
و هذه الحوادث : الخارقة للعادة ، هي الآيات المعجزة التي ينسبها إلى عدة من
الأنبياء الكرام .
كمعجزات : نوح ، و هود ، و صالح ، و إبراهيم ، و لوط ، و داود ، و سليمان ، و موسى
، و عيسى ، و محمد صلى الله عليهم وسلم ، فإنها أمور خارقة للعادة ، المستمرة في
نظام الطبيعة .
لكن يجب أن يعلم :
أن هذه : الأمور و الحوادث ، و إن أنكرتها العادة و استبعدتها
.
إلا أنها
: ليست أمورا مستحيلة بالذات ، بحيث يبطلها العقل الضروري .
كما يبطل :
قولنا : الإيجاب و
السلب يجتمعان معا ، و يرتفعان معا من كل جهة .
و قولنا : الشيء يمكن أن يسلب عن نفسه .
و
قولنا : الواحد ليس نصف الاثنين .
و أمثال ذلك : من الأمور الممتنعة بالذات .
كيف : و عقول
جم غفير من المليين ، منذ أعصار قديمة ، تقبل ذلك و ترتضيه من غير إنكار و رد .
و لو كانت
المعجزات : ممتنعة بالذات لم يقبلها عقل عاقل ، و لم يستدل بها على شيء ، و لم ينسبها
أحد إلى أحد .
على أن أصل هذه الأمور : أعني المعجزات ، ليس مما تنكره عادة الطبيعة .
بل هي : مما يتعاوره
نظام المادة كل حين .
بتبديل : الحي إلى ميت ، و الميت إلى الحي .
و تحويل : صورة إلى صورة ، و
حادثة إلى حادثة ، و رخاء إلى بلاء ، و بلاء إلى رخاء .
و إنما الفرق : بين صنع العادة ، و
بين المعجزة الخارقة .
هو أن : الأسباب المادية المشهودة التي بين أيدينا ، إنما تؤثر
أثرها مع روابط مخصوصة ، و شرائط زمانية و مكانية خاصة ، تقضي بالتدريج في التأثير
.
مثلا العصا : و إن أمكن أن تصير حية تسعى و الجسد البالي ، و إن أمكن أن يصير إنسانا
حيا .
لكن ذلك : إنما يتحقق في العادة ، بعلل خاصة و شرائط زمانية و مكانية مخصوصة ، تنتقل بها المادة من حال إلى حال
، و تكتسي صورة بعد صورة ، حتى تستقر و تحل بها الصورة
الأخيرة ، المفروضة على ما تصدقه المشاهدة و التجربة .
لا مع أي ك شرط اتفق ، أو من غير علة
، أو بإرادة مريد ، كما هو الظاهر من حال المعجزات و الخوارق التي يقصها القرآن .
و كما أن الحس و التجربة : الساذجين ، لا يساعدان على تصديق هذه الخوارق للعادة
.
كذلك النظر : العلمي الطبيعي ، لكونه معتمدا على السطح المشهود من نظام العلة و
المعلول الطبيعيين .
أعني به : السطح الذي تستقر عليه التجارب العلمية اليوم ، و
الفرضيات المعللة للحوادث المادية .
إلا أن حدوث : الحوادث الخارقة للعادة إجمالا ، ليس في وسع العلم إنكاره و الستر
عليه .
فكم من أمر عجيب : خارق للعادة ، يأتي به أرباب المجاهدة و أهل الأرتياض ، كل يوم ،
تمتلئ به العيون ، و تنشره النشريات ، و تضبطه الصحف و المسفورات ، بحيث لا يبقى
لذي لب في وقوعه شك ، و لا في تحققه ريب .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص76.
و هذا هو الذي : ألجأ الباحثين في الآثار الروحية من علماء العصر .
أن يعللوه : بجريان أمواج مجهولة ، إلكتريسية مغناطيسية
.
فافترضوا : أن الارتياضات الشاقة ، تعطي للإنسان سلطة على تصريف أمواج مرموزة قوية ، تملكه أو
تصاحبه إرادة و شعور ، و بذلك يقدر على ما يأتي به من حركات و تحريكات و تصرفات
عجيبة في المادة ، خارقة للعادة ، بطريق القبض و البسط ، و نحو ذلك .
و هذه الفرضية : لو تمت و أطردت من غير انتقاض .
لأدت : إلى تحقق فرضية جديدة وسيعة ، تعلل جميع الحوادث المتفرقة ، التي كانت
تعللها جميعا أو تعلل بعضها ، الفرضيات القديمة ، على محور الحركة و القوة .
و لساقت : جميع الحوادث المادية ، إلى التعلل و الارتباط بعلة واحدة طبيعية .
فهذا قولهم : و الحق معهم في الجملة .
إذ لا معنى : لمعلول طبيعي لا علة طبيعية له ، مع فرض كون الرابطة ، طبيعية محفوظة
.
و بعبارة أخرى : إنا لا نعني بالعلة الطبيعية ، إلا أن تجتمع عدة موجودات طبيعية ،
مع نسب و روابط خاصة ، فيتكون منها عند ذلك موجود طبيعي جديد ، حادث متأخر عنها
مربوط بها ، بحيث لو انتقض النظام السابق عليه لم يحدث و لم يتحقق وجوده .
و أما القرآن الكريم :
فإنه : و إن لم يشخص هذه العلة الطبيعية الأخيرة ، التي
تعلل جميع الحوادث المادية العادية ، و الخارقة للعادة على ما نحسبه ، بتشخيص
اسمه و كيفية تأثيره ، لخروجه عن غرضه العام .
إلا أنه مع ذلك : يثبت لكل حادث مادي سببا ماديا بإذن الله تعالى .
و بعبارة أخرى :
يثبت ( القرآن الكريم ) : لكل حادث مادي .
أنه مستند : في وجوده إلى الله سبحانه _ و الكل مستند
_ ( أي كل ما في الوجود مستند إلى الله تعالى ).
( فلكل شيء في التكوين ) : مجرى ماديا ، و طريقا طبيعيا ، به يجري فيض الوجود منه تعالى إليه .
قال تعالى : { وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ
يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ
وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرا ً(3) } الطلاق .
فإن صدر الآية : يحكم بالإطلاق من غير تقييد ، أن كل من اتقى الله و توكل عليه ، و
إن كانت الأسباب العادية المحسوبة عندنا أسبابا تقضي بخلافه ، و تحكم بعدمه ، فإن
الله سبحانه حسبه فيه ، و هو كائن لا محالة .
كما يدل عليه أيضا إطلاق قوله تعالى :
{ وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي
قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ (186) } البقرة .
و قوله تعالى : { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (60) } المؤمن .
و قوله تعالى : { أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ (36) } الزمر.
الميزان في تفسير القرآن، ج1، ص: 77.
ثم الجملة التالية : و هي قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ (3) }
الطلاق .
يعلل : إطلاق الصدر .
و في هذا المعنى قوله : { وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى
أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21) } يوسف .
و هذه جملة مطلقة : غير مقيدة بشيء البتة .
فلله سبحانه : سبيل إلى كل حادث
تعلقت به مشيته و إرادته ، و إن كانت السبل العادية و الطرق المألوفة مقطوعة منتفية
هناك .
و هذا يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يتوسل تعالى إليه من غير سبب مادي و علة طبيعية ، بل بمجرد
الإرادة وحدها .
و ثانيهما : أن يكون هناك سبب طبيعي ، مستور عن علمنا ، يحيط به الله سبحانه ، و
يبلغ ما يريده من طريقه .
إلا أن الجملة التالية : من الآية المعللة لما قبلها ، أعني قوله تعالى : {
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (3) } الطلاق .
تدل :
على ثاني الوجهين .
فإنها تدل :
على أن : كل شيء من المسببات ، أعم مما تقتضيه الأسباب العادية أو لا
تقتضيه .
فإن له : قدرا قدره الله سبحانه عليه ، و ارتباطات مع غيره من الموجودات ، و
اتصالات وجودية مع ما سواه .
لله سبحانه : أن يتوسل منها إليه ، و إن كانت الأسباب العادية مقطوعة عنه غير
مرتبطة به .
إلا أن هذه : الاتصالات و الارتباطات ، ليست مملوكة للأشياء أنفسها
.
حتى
تطيع : في حال ، و تعصي في أخرى .
بل مجعولة : بجعله تعالى ، مطيعة منقادة له .
فالآية تدل : على أنه تعالى جعل بين الأشياء جميعها ، ارتباطات و اتصالات ، له أن
يبلغ إلى كل ما يريد من أي وجه شاء .
و ليس هذا : نفيا للعلية و السببية بين الأشياء .
بل إثبات : أنها بيد الله سبحانه ، يحولها كيف شاء و أراد .
ففي الوجود : عليّة و ارتباط حقيقي ، بين كل موجود و ما تقدمه من الموجودات
المنتظمة .
غير أنها : ليست على ما نجده ، بين ظواهر الموجودات بحسب العادة ، بل على ما يعلمه
الله تعالى و ينظمه.
و لذلك نجد : الفرضيات العلمية الموجودة ، قاصرة عن تعليل جميع الحوادث الوجودية .
و هذه الحقيقة : هي التي تدل عليها آيات القدر :
كقوله تعالى : { وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما
نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) } الحجر .
و قوله تعالى : { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (49) } القمر .
و قوله تعالى : { وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (2) } الفرقان .
و قوله تعالى : { الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (3) } الأعلى
.
و كذا قوله تعالى : { ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي
أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها (22) } الحديد .
و قوله تعالى : { ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ مَنْ
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) }
التغابن .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص78 .
فإن الآية الأولى : و كذا بقية الآيات .
تدل على أن : الأشياء تنزل من ساحة الإطلاق ،
إلى مرحلة التعين و التشخص ، بتقدير منه تعالى ، و تحديد يتقدم على الشيء و يصاحبه
.
و لا معنى لكون الشيء : محدودا مقدرا في وجوده ، إلا أن يتحدد و يتعين بجميع روابطه
، التي مع سائر الموجودات .
و الموجود المادي : مرتبط بمجموعة من الموجودات المادية الأخرى ، التي هي كالقالب
الذي يقلب به الشيء ، و يعين وجوده و يحدده و يقدره .
فما من موجود مادي : إلا و هو متقدر ، مرتبط بجميع الموجودات المادية التي تتقدمه و
تصاحبه ، فهو معلول لآخر مثله لا محالة .
و يمكن أن يستدل أيضا على ما مر :
بقوله تعالى : { ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (62) } المؤمن .
و قوله تعالى : { ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي
عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) } هود .
فإن الآيتين : بانضمام ما مرت الإشارة إليه من أن الآيات القرآنية ، تصدق قانون
العلية العام ، وتنتج المطلوب .
و ذلك أن الآية الأولى : تعمم الخلقة لكل شيء ، فما من شيء إلا و هو مخلوق لله عز
شأنه .
و الآية الثانية : تنطق بكون الخلقة و الإيجاد على وتيرة واحدة ، و نسق منتظم ، من
غير اختلاف يؤدي إلى الهرج و الجزاف.
و القرآن كما عرفت : يصدق قانون العلية العام ، في ما بين الموجودات المادية .
ينتج أن : نظام الوجود في الموجودات المادية ، سواء كانت على جري العادة ، أو خارقة
لها ، على صراط مستقيم غير متخلف ، و وتيرة واحدة .
في استناد : كل حادث فيه ، إلى العلة المتقدمة عليه ، الموجبة له .
و من هنا يستنتج :
أن الأسباب العادية : التي ربما يقع التخلف
، بينها و بين مسبباتها
، ليست بأسباب حقيقية .
بل هناك : أسباب حقيقية مطردة ، غير متخلفة الأحكام و الخواص
.
كما ربما تؤيده: التجارب العلمية في جراثيم الحياة ، و في خوارق العادة ، كما مر .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص79 .
++
3 - القرآن يسند ما أسند إلى العلة المادية إلى الله تعالى :
ثم إن القرآن : كما يثبت بين الأشياء العلية و المعلولية ، و يصدق سببية البعض
للبعض ، كذلك يسند الأمر في الكل إلى الله سبحانه .
فيستنتج منه : أن الأسباب الوجودية غير مستقلة في التأثير ، و المؤثر الحقيقي بتمام
معنى الكلمة ، ليس إلا الله عز سلطانه .
قال تعالى : { أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ (53) } الأعراف .
و قال تعالى : { لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ (284) }
البقرة .
و قال تعالى : { لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ (5) } الحديد .
و قال تعالى : { قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (77) } النساء .
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة : الدالة على أن كل شيء مملوك محض لله ، لا يشاركه
فيه أحد ، و له أن يتصرف فيها كيف شاء و أراد .
و ليس لأحد : أن يتصرف في شيء منها ،
إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ، و يملكه التصرف ، من غير استقلال في هذا التمليك
أيضا .
بل مجرد إذن : لا يستقل به المأذون له ، دون أن يعتمد على إذن الإذن .
قال تعالى : { قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ
تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ (26) } آل عمران .
و قال تعالى : { الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى (50) )}
طه . إلى غير ذلك من الآيات .
و قال تعالى أيضا : { لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا
الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (255) } البقرة .
و قال تعالى : { ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ
شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ (3) } يونس .
فالأسباب : تملكت السببية بتمليكه تعالى ، و هي غير مستقلة في عين أنها مالكة .
و هذا المعنى : هو الذي يعبر سبحانه عنه ،
بالشفاعة ، و الإذن .
فمن المعلوم : أن الإذن إنما يستقيم معناه ، إذا كان هناك مانع من تصرف
المأذون فيه ، و المانع أيضا إنما يتصور فيما كان هناك مقتض موجود ، يمنع المانع عن
تأثيره و يحول بينه و بين تصرفه.
فقد بان : أن في كل سبب مبدأ مؤثرا ، مقتضيا للتأثير به ، يؤثر في مسببه ، و الأمر
مع ذلك لله سبحانه .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص80 .
++
====+++++====
( القسم السادس : في بيان إعجاز القرآن ، وهو أن القرآن
الكريم يثبت أن خرق العادة المعجز قوة في نفوس الأنبياء ، وهي مؤيد بإذن الله ، وأن
سببها غالب لا يقهر ولا يبطل ، وأن المعجزة هي لدعم مطلق الرسالة وتصديق دعوا
الأنبياء .
بعد أن عرفنا بتصرف عالم
الغيب وما وراء الطبيعة ، في عالم المادة والشهادة ، وفق قانون العلية والأسباب
المخفية علينا ، مع التحدي بأمر إلهي غير مغلوب ، فيصدق قدرة وعظم المرسل والرسول
والرسالة ، في تفسير الآية 23 من سورة البقرة ، بعد أن عرفنا تحدي القرآن ،
بالبلاغة ، والعلم ، وبمن أنزل عليه ، وبالإخبار بالغيب ، وعدم الاختلاف فيه ) .
4 - القرآن يثبت تأثيرا في نفوس الأنبياء في الخوارق :
ثم إنه تعالى قال : { وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ
فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ
(78) } المؤمن .
فأفاد : إناطة إتيان أية آية من أي رسول ، بإذن الله
سبحانه .
فبين :
أن إتيان : الآيات المعجزة ، من الأنبياء ، و صدورها عنهم.
إنما هو : لمبدأ مؤثر
موجود في نفوسهم الشريفة ، متوقف في تأثيره على الإذن ، كما مر في الفصل السابق .
و قال تعالى : { وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ
وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ
وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ
عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ
وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا
تَكْفُرْ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ
ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (102) } البقرة .
و الآية كما أنها تصدق : صحة السحر في الجملة .
كذلك تدل على أن السحر : أيضا كالمعجزة ، في كونه عن مبدأ نفساني في
الساحر ، لمكان الإذن .
و بالجملة : جميع الأمور الخارقة للعادة .
سواء سميت : معجزة ، أو سحرا ، أو غير ذلك ، ككرامات الأولياء ، و سائر
الخصال المكتسبة بالارتياضات و المجاهدات .
جميعها مستندة : إلى مباد نفسانية ، و مقتضيات إرادية ، على ما يشير إليه كلامه
سبحانه .
إلا أن كلامه ينص : على أن المبدأ الموجود عند الأنبياء و الرسل و المؤمنين ، هو
الفائق الغالب على كل سبب ، و في كل حال .
قال تعالى : { وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ
لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ (173) } الصافات .
و قال تعالى : { كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي (21) } المجادلة .
و قال تعالى : { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي
الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (51) } المؤمن.
و الآيات : مطلقة غير مقيدة.
و من هنا يمكن أن يستنتج : أن هذا المبدأ الموجود المنصور ، أمر وراء الطبيعة ، و
فوق المادة .
فإن الأمور المادية : مقدرة محدودة ،
مغلوبة لما هو فوقها قدرا و حدا ، عند التزاحم و
المغالبة .
و الأمور المجردة أيضا :
و إن كانت كذلك ، إلا أنها لا تزاحم بينها ، و لا تمانع
إلا أن تتعلق بالمادة بعض التعلق .
و هذا المبدأ النفساني المجرد : المنصور بإرادة الله سبحانه ،
إذا قابل مانعا ماديا
، أفاض إمدادا على السبب ، بما لا يقاومه سبب مادي يمنعه ، فافهم .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص81 .
+++
5 - القرآن كما يسند الخوارق إلى تأثير النفوس يسندها إلى أمر الله تعالى :
ثم إن الجملة الأخيرة : من الآية السابقة في الفصل السابق .
أعني قوله تعالى : { فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِ ...(78) }
المؤمن .
تدل على أن تأثير : هذا المقتضي ، يتوقف على أمر من الله تعالى ، يصاحب الإذن الذي
كان يتوقف عليه أيضا .
فتأثير هذا المقتضي : يتوقف على مصادفته الأمر ، أو اتحاده معه .
و قد فسر الأمر في قوله تعالى : { إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) } يس .
بكلمة : الإيجاد ، و قول :{ كن } .
و قال تعالى : { إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ
سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا (30) } الإنسان .
و قال : { إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (27) لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن
يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
(29) } التكوير .
دلت الآيات : على أن الأمر الذي للإنسان إن يريده ، و بيده زمام اختياره ، لا
يتحقق موجودا إلا أن يشاء الله ذلك ، بأن يشاء أن يشاء الإنسان ، و يريد إرادة
الإنسان .
فإن الآيات الشريفة : في مقام أن أفعال الإنسان الإرادية ، و إن كانت بيد الإنسان
بإرادته ، لكن الإرادة و المشية ليست بيد الإنسان ، بل هي مستندة إلى مشية الله
سبحانه .
و ليست في مقام بيان : أن كل ما يريده الإنسان ، فقد أراده الله .
فإنه خطأ فاحش : و لازمه أن يتخلف الفعل عن إرادة الله سبحانه ، عند تخلفه عن إرادة
الإنسان ، تعالى الله عن ذلك .
مع أنه خلاف : ظواهر الآيات الكثيرة ، الواردة في هذا المورد .
كقوله تعالى : { وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها (13) } السجدة .
و قوله تعالى : { وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ
جَمِيعاً (99) } يونس، إلى غير ذلك .
فإرادتنا و مشيئتنا : إذا تحققت فينا ،
فهي مرادة بإرادة الله و مشيئته لها ، و كذا
أفعالنا مرادة له تعالى من طريق إرادتنا و مشيتنا بالواسطة .
و هما : أعني الإرادة و الفعل ، جميعا متوقفان على أمر الله سبحانه ، و كلمة : {
كن} .
فالأمور جميعا :
سواء : كانت عادية ، أو خارقة للعادة .
و سواء : كان خارق العادة في جانب الخير و السعادة ، كالمعجزة و الكرامة ، أو
في جانب الشر ، كالسحر و الكهانة .
مستندة في تحققها : إلى أسباب طبيعية ، و هي مع ذلك متوقفة على إرادة الله .
لا توجد : إلا بأمر الله سبحانه ، أي بأن يصادف السبب ، أو يتحد مع أمر الله
سبحانه.
و جميع الأشياء : و إن كانت من حيث استناد وجودها إلى الأمر الإلهي على حد سواء ،
بحيث :
إذا تحقق : الإذن و الأمر ، تحققت عن أسبابها .
و إذا لم يتحقق : الإذن و الأمر ،
لم تتحقق ، أي لم تتم السببية .
إلا أن قسما منها :
و هو المعجزة : من الأنبياء ، أو ما سأله عبد ربه بالدعاء ،
لا
يخلو عن إرادة موجبة منه تعالى ، و أمر عزيمة .
كما يدل عليه قوله : { كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي .... (21)
الآية } المجادلة .
و قوله تعالى : { أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ ..... (186)
الآية } البقرة .
و غير ذلك : من الآيات ، المذكورة في الفصل السابق.
الميزان في تفسير القرآن ج1ص82 .
+++
6 - القرآن يسند المعجزة إلى سبب غير مغلوب :
فقد تبين : من الفصول السابقة من البحث .
أن المعجزة : كسائر الأمور الخارقة للعادة ، لا تفارق الأسباب العادية في الاحتياج
إلى سبب طبيعي ، و أن مع الجميع أسبابا باطنية .
و أن الفرق بينها :
أن الأمور العادية : ملازمة لأسباب ظاهرية ، تصاحبها الأسباب الحقيقية
الطبيعية غالبا أو مع الأغلب ، و مع تلك الأسباب الحقيقية إرادة الله و أمره .
و الأمور الخارقة للعادة : من الشرور كالسحر و الكهانة ، مستندة إلى أسباب طبيعية ،
مفارقة للعادة، مقارنة للسبب الحقيقي بالإذن و الإرادة .
كاستجابة الدعاء : و نحو ذلك ، من غير تحد ، يبتني عليه ظهور حق الدعوة .
و أن المعجزة : مستندة إلى سبب طبيعي حقيقي ، بإذن الله و أمره ، إذا كان هناك تحد
، يبتني عليه صحة النبوة و الرسالة ، و الدعوة إلى الله تعالى .
و أن القسمين الآخرين : يفارقان سائر الأقسام ، في أن سببهما لا يصير مغلوبا مقهورا
قط ، بخلاف سائر المسببات .
فإن قلت :
فعلى هذا : لو فرضنا الإحاطة و البلوغ إلى السبب الطبيعي ، الذي للمعجزة
.
كانت المعجزة : ميسورة ممكنة الإتيان لغير النبي أيضا ، و لم يبق فرق بين المعجزة و
غيرها ، إلا بحسب النسبة و الإضافة فقط .
فيكون حينئذ أمر : ما معجزة بالنسبة إلى قوم ، غير معجزة بالنسبة إلى آخرين ، و هم
المطلعون على سببها الطبيعي الحقيقي ، و في عصر دون عصر ، و هو عصر العلم .
فلو ظفر البحث العلمي : على الأسباب الحقيقية الطبيعية القصوى ، لم يبق مورد
للمعجزة ، و لم تكشف المعجزة عن الحق .
و نتيجة هذا البحث : أن المعجزة لا حجية فيها ، إلا على الجاهل بالسبب ، فليست حجة
في نفسها .
قلت :
كلا : فليست المعجزة معجزة ، من حيث إنها مستندة إلى سبب طبيعي مجهول ، حتى
تنسلخ عن اسمها عند ارتفاع الجهل ، و تسقط عن الحجية ، و لا أنها معجزة من حيث
استنادها إلى سبب مفارق للعادة .
بل هي معجزة : من حيث إنها مستندة إلى أمر مفارق للعادة ، غير مغلوب السبب ، قاهرة
العلة البتة .
و ذلك : كما أن الأمر الحادث من جهة استجابة الدعاء كرامة ، من حيث استنادها إلى
سبب غير مغلوب ، كشفاء المريض .
مع أنه : يمكن أن يحدث من غير جهته ، كجهة العلاج
بالدواء .
غير أنه : حينئذ أمر عادي يمكن أن يصير سببه مغلوبا مقهورا ، بسبب آخر أقوى
منه .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص83 .
+++
7 - القرآن يعد المعجزة برهانا على صحة الرسالة لا دليلا عاميا :
و هاهنا سؤال : و هو أنه ما هي الرابطة ، بين المعجزة ، و بين حقية
دعوى الرسالة ؟
مع أن العقل : لا يرى تلازما بين صدق الرسول في دعوته إلى الله سبحانه ، و بين صدور
أمر خارق للعادة عن الرسول ، على أن الظاهر من القرآن الشريف .
تقرير ذلك : فيما يحكيه ، من قصص عدة من الأنبياء : كهود ، و صالح ، و موسى ،
و عيسى ، و محمد صلى الله عليهم وسلم .
فإنهم : على ما يقصه القرآن حينما بثوا دعوتهم
، سئلوا عن آية تدل على حقية دعوتهم ، فأجابوهم فيما سئلوا و جاءوا بالآيات.
و ربما أعطوا المعجزة : في أول البعثة ، قبل أن يسألهم أممهم شيئا من ذلك .
كما قال تعالى في موسى و هارون عليهما السلام : { اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ
بِآياتِي وَ لا تَنِيا فِي ذِكْرِي (42) } طه .
و قال تعالى في عيسى عليه السلام : { وَ رَسُولًا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ
أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ
الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ
اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ
اللَّهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49 } آل عمران .
و كذا إعطاء القرآن : معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم .
و بالجملة : فالعقل الصريح ، لا يرى تلازما بين حقية ما أتى به الأنبياء و
الرسل من معارف المبدأ و المعاد ، و بين صدور أمر يخرق العادة عنهم .
مضافا إلى أن : قيام البراهين الساطعة على هذه الأصول الحقة ، يغني العالم البصير
بها عن النظر في أمر الإعجاز .
و لذا قيل : إن المعجزات لإقناع نفوس العامة ، لقصور عقولهم عن إدراك الحقائق
العقلية ، و أما الخاصة فإنهم في غنى عن ذلك .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص84 .
و الجواب عن هذا السؤال :
أن الأنبياء و الرسل عليهم السلام : لم يأتوا بالآيات المعجزة لإثبات شيء من معارف
المبدأ و المعاد ، مما يناله العقل ، كالتوحيد و البعث و أمثالها .
و إنما
اكتفوا : في ذلك ، بحجة العقل ، و المخاطبة من طريق النظر و الاستدلال .
كقوله تعالى : { قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ
الْأَرْضِ (10) } إبراهيم .
في الإحتجاج : على التوحيد .
قوله تعالى : { وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا
ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ
نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي
الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) } ص .
في الإحتجاج : على
البعث .
و إنما سئل الرسل : المعجزة ، و أتوا بها لإثبات رسالتهم و تحقيق دعواها .
و ذلك أنهم : ادعوا الرسالة من الله بالوحي ، و أنه بتكليم إلهي ، أو نزول ملك ، و
نحو ذلك .
و هذا شيء : خارق للعادة في نفسه ، من غير سنخ الإدراكات الظاهرة و الباطنة ، التي
يعرفها عامة الناس و يجدونها من أنفسهم .
بل إدراك مستور : عن عامة النفوس ، لو صح وجوده لكان تصرفا خاصا من ما وراء الطبيعة
في نفوس الأنبياء فقط ، مع أن الأنبياء كغيرهم من أفراد الناس في البشرية و قواها .
و لذلك صادفوا : إنكارا شديدا من الناس ، و مقاومة عنيفة في رده .
على أحد وجهين :
فتارة :
حاول الناس إبطال دعواهم بالحجة :
كقوله تعالى : { قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ
تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا (10) } إبراهيم .
استدلوا فيها : على بطلان دعواهم الرسالة ، بأنهم مثل سائر الناس ، و الناس لا
يجدون شيئا مما يدعونه من أنفسهم ، مع وجود المماثلة ، و لو كان لكان في الجميع ،
أو جاز للجميع هذا .
و لهذا أجاب الرسل : عن حجتهم ، بما حكاه الله تعالى عنهم .
بقوله : { قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ
لكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ 014) } إبراهيم .
فردوا عليهم : بتسليم المماثلة .
و أن الرسالة : من منن الله الخاصة ، و الاختصاص
ببعض النعم الخاصة ، لا ينافي المماثلة ، فللناس اختصاصات.
نعم : لو شاء أن يمتن على
من يشاء منهم ، فعل ذلك من غير مانع .
فالنبوة : مختصة بالبعض ، و إن جاز على الكل .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص85 .
و نظير هذا الاحتجاج : قولهم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
على ما حكاه الله تعالى : { أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا
(8) } ص .
و قولهم كما حكاه الله : { لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ
مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) } الزخرف .
و نظير هذا الاحتجاج : أو قريب منه : ما في قوله تعالى : { وَ قالُوا ما لِهذَا
الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ لا أُنْزِلَ
إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ
تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها (8) } الفرقان .
و وجه الاستدلال : أن دعوى الرسالة ، توجب أن لا يكون بشرا مثلنا ، لكونه ذا
أحوال من الوحي ، و غيره ليس فينا .
فلِم يأكل الطعام : و يمشي في الأسواق لاكتساب المعيشة ؟
بل يجب : أن ينزل معه ملك يشاركه في الإنذار ، أو يلقى إليه كنز ، فلا يحتاج إلى
مشي الأسواق للكسب ، أو تكون له جنة فيأكل منها ، لا مما نأكل منه من طعام .
فرد الله تعالى عليهم بقوله :
{ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلًا } .. إلى أن قال ..{ وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ وَ
جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ وَ كانَ رَبُّكَ بَصِيراً
(20) } الفرقان .
و رد تعالى : في موضع آخر ، مطالبتهم مباشرة الملك للإنذار :
بقوله : { وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا وَ لَلَبَسْنا
عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ (9) } الأنعام .
و قريب من ذلك الاحتجاج أيضا :
ما في قوله تعالى : { وَ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ
عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً (21) } الفرقان .
فأبطلوا بزعمهم : دعوى الرسالة بالوحي ، بمطالبة أن يشهدوا نزول الملك ، أو
رؤية الرب سبحانه ، لمكان المماثلة مع النبي .
فرد الله تعالى عليهم ذلك :
بقوله : { يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ
يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً (22) } الفرقان .
فذكر أنهم : و الحال حالهم لا يرون الملائكة ، إلا مع حال الموت ، كما ذكره
في موضع آخر .
بقوله تعالى : { وَ قالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ
لَمَجْنُونٌ لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ما
نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ (8) }
الحجر .
و تشتمل هذه الآيات الأخيرة :
على زيادة في وجه الاستدلال ، و هو تسليم صدق
النبي صلى الله عليه وآله في دعواه ، إلا أنه مجنون ، و ما يحكيه و يخبر به ، أمر
يسوله له الجنون غير مطابق للواقع .
كما في موضع آخر من قوله : { وَ قالُوا مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ (9) } القمر .
و بالجملة : فأمثال هذه الآيات ، مسوقة لبيان إقامتهم الحجة على إبطال دعوى النبوة
، من طريق المماثلة .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص86 .
++
و تارة أخرى :
أقاموا
أنفسهم مقام الإنكار ، و سؤال الحجة و البينة على صدق الدعوة .
_كلام في معنى الرسالة و ما يلحق بها _ .
لاشتمالها : على ما تنكره النفوس و لا تعرفه العقول ، على طريقة المنع مع السند
باصطلاح فن المناظرة .
و هذه البينة : هي المعجزة .
بيان ذلك : أن دعوى النبوة و الرسالة ، من كل نبي و رسول على ما يقصه القرآن
.
إنما
كانت : بدعوى الوحي و التكليم الإلهي بلا واسطة ، أو بواسطة نزول الملك .
و هذا أمر : لا
يساعد عليه الحس ، و لا تؤيده التجربة .
فيتوجه عليه الإشكال من جهتين :
إحداهما : من جهة
عدم الدليل عليه .
و الثانية : من جهة الدليل على عدمه .
فإن الوحي و التكليم الإلهي : و
ما يتلوه من التشريع ، و التربية الدينية .
مما لا يشاهده : البشر من أنفسهم ، و العادة
الجارية في الأسباب و المسببات تنكره .
فهو أمر : خارق للعادة ، و قانون العلية العامة
لا يجوزه .
فلو كان النبي : صادقا في دعواه النبوة و الوحي ، كان لازمه أنه متصل بما
وراء الطبيعة ، مؤيد بقوة إلهية تقدر على خرق العادة ، و أن الله سبحانه يريد بنبوته و
الوحي إليه خرق العادة .
فلو كان هذا حقا : و لا فرق بين خارق و خارق ، كان من الممكن أن
يصدر من النبي خارق آخر للعادة ، من غير مانع ، و أن يخرق الله العادة بأمر آخر يصدق
النبوة و الوحي ، من غير مانع عنه ، فإن حكم الأمثال واحد .
فلئن أراد الله : هداية الناس
بطريق خارق للعادة ، و هو طريق النبوة و الوحي ، فليؤيدها و ليصدقها بخارق آخر ، و هو
المعجزة .
و هذا هو الذي : بعث الأمم إلى سؤال المعجزة على صدق دعوى النبوة ، كلما جاءهم رسول من
أنفسهم ، بعثا بالفطرة و الغريزة.
و كان سؤال المعجزة : لتأييد الرسالة و تصديقها ، لا
للدلالة على صدق المعارف الحقة ، التي كان الأنبياء يدعون إليها ، مما يمكن أن يناله
البرهان ، كالتوحيد ، و المعاد .
و نظير هذا : ما لو جاء رجل بالرسالة إلى قوم ، من قبل
سيدهم الحاكم عليهم ، و معه أوامر و نواه يدعيها للسيد .
فإن بيانه لهذه الأحكام : و
إقامته البرهان على أن هذه الأحكام مشتملة ، على مصلحة القوم ، و هم يعلمون أن سيدهم لا
يريد إلا صلاح شأنهم ، إنما يكفي في كون الأحكام التي جاء بها حقة صالحة للعمل .
و لا تكفي : البراهين و الأدلة المذكورة في صدق رسالته ، و أن سيدهم أراد منهم بإرساله إليهم
ما جاء به من الأحكام .
بل يطالبونه : ببينة أو علامة ، تدل على صدقه في دعواه ، ككتاب بخطه
و خاتمه يقرءونه ، أو علامة يعرفونها .
كما قال المشركون للنبي : { حَتَّى تُنَزِّلَ
عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ (93) } إسراء .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص87 .
(فالقرآن : هو معجزة خالدة على رسالة نبينا الأكرم وصدق دعوته )
فقد تبين بما ذكرناه :
أولا : التلازم بين صدق دعوى الرسالة و بين المعجزة ، و أنها
الدليل على صدق دعواها ، ولا يتفاوت في ذلك حال الخاصة و العامة في دلالتها و إثباتها
.
و ثانيا : أن ما يجده الرسول و النبي من الوحي و يدركه منه ، من غير سنخ ما نجده
بحواسنا و عقولنا النظرية الفكرية .
فالوحي : غير الفكر الصائب ، و هذا المعنى في كتاب
الله تعالى من الوضوح و السطوع ، بحيث لا يرتاب فيه من له أدنى فهم ، و أقل إنصاف .
+
و قد انحرف في ذلك :
جمع من الباحثين : من أهل العصر ، فراموا بناء المعارف الإلهية و
الحقائق الدينية ، على ما وصفه العلوم الطبيعية ، من أصالة المادة المتحولة المتكاملة
.
فقد رأوا : أن الإدراكات الإنسانية ، خواص مادية مترشحة من الدماغ ، و أن الغايات
الوجودية و جميع الكمالات الحقيقية استكمالات فردية ، أو اجتماعية مادية .
فذكروا أن النبوة : نوع نبوغ فكري ، و صفاء ذهني ، يستحضر به الإنسان المسمى نبيا ، كمال
قومه الاجتماعي .
و يريد به : أن يخلصهم من ورطة الوحشية و البربرية ، إلى ساحة الحضارة و
المدنية .
فيستحضر : ما ورثه من العقائد و الآراء ، و يطبقها على مقتضيات عصره و محيط
حياته .
فيقنن لهم : أصولا اجتماعية ، و كليات عملية ، يستصلح بها أفعالهم الحيوية ، ثم يتمم
ذلك بأحكام و أمور عبادية ، ليستحفظ بها خواصهم الروحية ، لافتقار الجامعة الصالحة
، و
المدنية الفاضلة إلى ذلك .
و يتفرع على هذا الافتراض :
أولا : أن النبي إنسان متفكر نابغ ، يدعو قومه إلى صلاح محيطهم الاجتماعي .
و ثانيا : أن الوحي هو أنتقاش الأفكار الفاضلة في ذهنه .
و ثالثا : أن الكتاب السماوي مجموع هذه الأفكار الفاضلة ، المنزهة عن التهوسات
النفسانية ، و الأغراض النفسانية الشخصية .
و رابعا : أن الملائكة التي أخبر بها النبي ، قوى طبيعية ، تدبر أمور الطبيعة ، أو قوى
نفسانية تفيض كمالات النفوس عليها .
و أن روح القدس : مرتبة من الروح الطبيعية المادية
، تترشح منها هذه الأفكار المقدسة .
و أن الشيطان : مرتبة من الروح ، تترشح منها الأفكار الردية ، و تدعو إلى الأعمال الخبيثة
، المفسدة للاجتماع .
و على هذا الأسلوب : فسروا
الحقائق التي أخبر بها الأنبياء ، كاللوح ، و القلم ، و العرش ، و الكرسي ، و الكتاب
، و الحساب
، و الجنة ، و النار ، بما يلائم الأصول المذكورة .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص88 .
و خامسا : أن الأديان تابعة لمقتضيات أعصارها ، تتحول بتحولها .
و سادسا : أن المعجزات المنقولة عن الأنبياء المنسوبة إليهم ، خرافات مجعولة أو حوادث
محرفة لنفع الدين ، و لحفظ عقائد العامة عن التبدل بتحول الأعصار ، أو لحفظ مواقع أئمة
الدين و رؤساء المذهب عن السقوط و الاضمحلال ، إلى غير ذلك مما أبدعه قوم ، و تبعهم
آخرون .
هذه جمل : ما ذكروه .
و النبوة بهذا المعنى : لأن تسمى لعبة سياسية ، أولى بها من أن تسمى
نبوة إلهية .
و الكلام التفصيلي : في أطراف ما ذكروه ، خارج عن البحث المقصود في هذا
المقام.
و الذي يمكن أن يقال فيه هاهنا :
أن الكتب السماوية : و البيانات النبوية المأثورة على
ما بأيدينا ، لا توافق هذا التفسير ، و لا تناسبه أدنى مناسبة .
و إنما دعاهم : إلى هذا
النوع من التفسير ، إخلادهم إلى الأرض ، و ركونهم إلى مباحث المادة .
فاستلزموا : إنكار ما
وراء الطبيعة ، و تفسير الحقائق المتعالية عن المادة ، بما يسلخها عن شأنها ، و تعيدها
إلى المادة الجامدة .
و ما ذكره هؤلاء : هو في الحقيقة ، تطور جديد فيما كان يذكره آخرون .
فقد كانوا يفسرون
: جميع الحقائق المأثورة في الدين بالمادة ، غير أنهم كانوا يثبتون لها وجودات غائبة عن
الحس ، كالعرش و الكرسي ، و اللوح و القلم ، و الملائكة و نحوها ، من غير مساعدة الحس و
التجربة على شيء من ذلك .
ثم لما اتسع : نطاق العلوم الطبيعية ، و جرى البحث على أساس
الحس و التجربة .
لزم الباحثين : على ذلك الأسلوب ، أن ينكروا لهذه الحقائق وجوداتها
المادية الخارجة عن الحس أو البعيدة عنه .
و أن يفسروها : بما تعيدها إلى الوجود المادي
المحسوس ، ليوافق الدين ما قطع به العلم ، و يستحفظ بذلك عن السقوط .
فهاتان الطائفتان : بين باغ و عاد .
أما القدماء من المتكلمين : فقد فهموا من البيانات
الدينية مقاصدها حق الفهم ، من غير مجاز .
غير أنهم رأوا : أن مصاديقها جميعا أمور مادية
محضة ، لكنها غائبة عن الحس ، غير محكومة بحكم المادة أصلا .
و الواقع : خلافه .
و أما
المتأخرون : من باحثي هذا العصر ، ففسروا البيانات الدينية ، بما أخرجوها به عن مقاصدها
البينة الواضحة ، و طبقوها على حقائق مادية ينالها الحس ، و تصدقها التجربة .
مع أنها :
ليست بمقصوده ، و لا البيانات اللفظية تنطبق على شيء منها.
+
و البحث الصحيح :
يوجب : أن تفسر هذه البيانات اللفظية ، على ما يعطيها اللفظ في العرف و
اللغة .
ثم يعتمد : في أمر المصداق ، على ما يفسر به بعض الكلام بعضا .
ثم ينظر : هل الأنظار
العلمية تنافيها أو تبطلها ؟
فلو ثبت فيها : في خلال ذلك ، شيء خارج عن المادة و حكمها
.
فإنما الطريق إليه : إثباتا أو نفيا ، طور آخر من البحث ، غير البحث الطبيعي الذي تتكفله
العلوم الطبيعية .
فما للعلم الباحث : عن الطبيعة ، و للأمر الخارج عنها ؟
فإن العلم
: الباحث عن المادة و خواصها ، ليس من وظيفته أن يتعرض لغير المادة و خواصها ، لا إثباتا
و لا نفيا .
و لو فعل : شيئا منه ، باحث من بحاثه ، كان ذلك منه شططا من القول .
نظير ما : لو أراد
الباحث في علم اللغة ، أن يستظهر من علمه ، حكم الفلك ، نفيا أو إثباتا .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص89 .
++++++
=======
( فمن لم يأتي بمثل سور القرآن فعليه أن يتلزم بباقي الآيات
)
{
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (24)
وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ
أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها
مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ
مُتَشابِهاً
وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فِيها خالِدُونَ
(25) } البقرة
.
[سورة البقرة (2): الآيات 21 الى 25]
الميزان في تفسير القرآن ج1ص57.
بيان : و لنرجع إلى بقية الآيات :
و قوله تعالى : { فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ
}.
سوق الآيات : من أول السورة ، و إن كانت لبيان حال ، المتقين ، و الكافرين ، و المنافقين
، الطوائف الثلاث جميعا .
لكنه سبحانه : حيث جمعهم طرا .
في قوله : { يا أَيُّهَا النَّاسُ
اعْبُدُوا رَبَّكُمُ }.
و دعاهم : إلى عبادته ، تقسموا لا محالة ، إلى مؤمن و غيره .
فإن هذه
الدعوة : لا تحتمل من حيث إجابتها و عدمها .
غير القسمين : المؤمن ، و
الكافر .
و أما
المنافق : فإنما يتحقق بضم الظاهر إلى الباطن ، و اللسان إلى القلب .
فكان هناك : من جمع
بين اللسان و القلب ، إيمانا ، أو كفرا .
و من اختلف : لسانه و قلبه ، و هو المنافق .
فلما
ذكرنا : لعله أسقط المنافقون من الذكر ، و خص بالمؤمنين و الكافرين ، و وضع الإيمان
مكان التقوى .
ثم إن الوقود : ما توقد به النار ، و قد نصت الآية على أنه نفس الإنسان .
فالإنسان : وقود
و موقود عليه .
كما في قوله تعالى أيضا : { ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) } المؤمن .
و قوله تعالى : { نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
الْأَفْئِدَةِ (7) } اللمزة .
فالإنسان : معذب بنار توقده نفسه .
و هذه الجملة نظيره
قوله تعالى : { كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي
رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً (25) } البقرة .
ظاهرة في أنه : ليس
للإنسان هناك إلا ما هيأه من هاهنا .
كما
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : [ كما تعيشون تموتون ، و كما
تموتون تبعثون ] الحديث .
و إن كان بين الفريقين : فرق ، من حيث إن لأهل الجنة مزيدا عند ربهم .
قال
تعالى : { لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ (35) } ق .
و المراد بالحجارة في قوله : { وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ },
الأصنام : التي
كانوا يعبدونها .
و يشهد به قوله تعالى : { إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ... (98) الآية } الأنبياء .
و الحصب : هو الوقود .
و قوله تعالى : { لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ }.
قرينة الأزواج : تدل على أن المراد
بالطهارة ، هي الطهارة من أنواع الأقذار و المكاره ، التي تمنع من تمام الالتيام و
الألفة و الأنس ، من الأقذار و المكاره الخلقية و الخلقية .
بحث روائي :
روى الصدوق قال: سئل الصادق عليه السلام عن الآية .
فقال : الأزواج المطهرة ، اللاتي لا يحضن و
لا يحدثن.
أقول : و في بعض الروايات ، تعميم الطهارة : للبراءة عن جميع العيوب و المكاره .
الميزان في تفسير القرآن، ج1، ص: 90.
http://www.alanbare.com/almezan
الميزان في تفسير الميزان
للعلامة محمد حسين الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية
استخرج التفسير الموضوعي منه ورتب فهارسه
وأعد الصفحة للإنترنيت
خادم
علوم آل محمد عليهم السلام
الشيخ
حسن جليل حردان الأنباري
موسوعة
صحف الطيبين